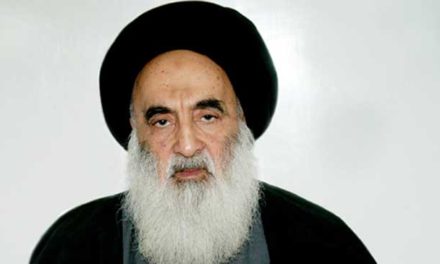إن إحدى المسائل التي تطرح بصورة ملحّة في الكثير من بلدان العالم اليوم، وبخاصة في إيران، مسألة العنف واللاعنف، فهلاّ تفضلتم ببيان وجهة نظركم حول هذه المسألة؟.
بسم الله الرحمن الرحيم
بصورة عامة أن الناس يعيشون حياةً اجتماعيةً، والحياة الاجتماعية التي تراعى فيها حقوق جميع الطبقات والأفراد، ويسودها الأمن الجماعي، لا تتيسر من دون قانون ونظام، والقانون بحاجة إلى منفذين يمتازون بالخبرة والدراية والتدبير وسعة الصدر وعدم التحيز لطرف على حساب طرف آخر..
وبالطبع فإن منفذي القانون، ينبغي أن يتعاملوا مع المسيئين والمتجاوزين، طبقاً للقوانين المقررة لهم، وهذا أمر ضروري، ومتفق عليه من قبل سائر النظم الاجتماعية، ولا يوجد أي نظام يطلق أيدي القتلة واللصوص والجناة ليفعلوا ما يريدون، بحجة احترام الحرية.
نعم إن الله عزّ وجلّ خلق الناس أحراراً، ولكل إنسان حقوقه، ولكن لو تقاطعت الحقوق الفردية مع حقوق مجتمع صالح متكافل آمن، فإن واضع القانون لابد أن يجعل مصلحة الأهم معياراً، ومن الطبيعي أن تُقيّد الكثير من الحقوق والحريات الفردية، سواء في ظل القوانين والنظم السماوية أو الوضعية.
في الدين الإسلامي الحنيف كذلك، فقد أمر الله عزّ وجلّ – وهو خالق الناس والعارف بمصالحهم ومضارهم- بالقصاص وإجراء الحد الشرعي، عند ارتكاب بعض الجنايات والجرائم الكبيرة، والذي يستفاد من بعض الأحاديث الشريفة أن تطبيقهما (القصاص والحدّ) أنفع للناس من أربعين يوماً ينزل فيها المطر متواصلاً.
وقد عُينت الحدود الشرعية في الإسلام على نحوٍ بحيث لو تجاوزها مجري الحدّ، كائناً من يكون لوجب أن يُقتّص منه.
ورد في رواية أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أمر خادمه قنبر أن يجري الحدّ على رجل، فزاد قنبر على الحدّ المقرر بثلاث جلدات، فما كان من الإمام (ع) إلا أن اقتص من خادمه بثلاث جلدات مثلها (الوسائل 3/3، مقدمات الحدود).
إذن القصاص هو حق عام، كما أن إجراء الحدود الشرعية في موارد معينة، لا يُعدّ عنفاً، وإنما هو أمرٌ الهدف منه تحقيق العدالة، واستتباب الأمن العام، وحفظ مصالح المجتمع.. وبالتالي فإن الجزاء العادل هو غير العنف تماماً.
وهنا ينبغي أن أضيف بأن السلطات التنفيذية في أي بلد وفي ظل أي نظام تضرب على أيدي منتهكي حقوق الناس، وتقف بوجههم بجدية، وهذا الأمر لا يمكن بحال أن نسميه عنفاً، ومثله قيام القوات المسلحة لبلد ما بالتصدي لأي عدوان خارجي، وهو ما يتطابق مع العقل والمنطق والفطرة.
إن اتخاذ موقف الدفاع إزاء تهديد خارجي ليس عنفاً، بل أمر مطابقٌ للعدالة والدفاع عن الحقوق.
إن العنف أن تقوم حكومة ما بالتنكيل بشعبها، إذ انتقد سياساتها غير المنطقية، وطالب بحقوقه المشروعة، عوضاً من أن تستجيب لمطالبه وترضيه وتترفق به، وتبحث عن طرق لتصحيح الأخطاء وإزالة الانحرافات، فهو (الشعب) صاحب السلطة الحقيقي.
فبدل أن تفعل مثل ذلك، تراها تتعامل معه كما لو كان عدواً خارجياً، هذا على حين أن الله سبحانه وتعالى يصف أتباع الرسول الكريم (ص)، في سورة الفتح، بقوله: (والذين معه أشداء على الكفّار رحماء بينهم). ويظهر من الآية الكريمة أن المقصود من الكفّار المشركين والأعداء الخارجيين، وليس أولئك الذين يعيشون في كنف بلاد الإسلام، ولا أولئك الذين تقيم معهم الدولة الإسلامية روابط حسنة.
العنف هو أن يعمد المنتصر في الحرب، بعد تحقيق الغلبة على العدو، إلى الانتقام والإمعان في القتل والقمع، في حين أن شكر نعمة الانتصار يستوجب من المنتصر أن يصفح ويعطف على بقايا العدو الذين نجوا من القتل.
إن الرسول الأكرم (ص)، بعد أن فتح مكة، توجه بالخطاب إلى بقايا قريش، قائلاً: (يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟) قالوا: (خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم)، فقال(ص): (اذهبوا فانتم الطلقاء) فعفا عنهم (الكامل لابن أثير: 2/252)، على الرغم من أن قريش شنت حروباً قاسية على المسلمين في مواقع بدر وأحد والخندث..ونحوها..
فكان أن عفا رسول الله (ص) حتى عن أبي سفيان وهند ووحشي قاتل حمزة (ره) عمّ النبي (ص)، بل إن الرسول الكريم (ص) أعلن بأن بيت أبي سفيان، الذي طالما خطط وغذّى معارك المشركين ضد المسلمين، مكاناً آمناً، فقال: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن).
وروي عن الأصبغ بن نباته أن الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وإثر انتصاره في معركة الجمل التي أججها طلحة والزبير وعائشة، أمر جنده، قائلاً: (لا تجهزوا على جرحاهم، ولا تتعقبوا الفارّين منهم، وكل من ألقى سلاحه على أرض المعركة فهو في أمان).
ثم جاء الإمام (ع) ومعه أصحابه إلى منزل، تجلس عائشة في إحدى غرفه، وفي غرفة أخرى يجلس مروان بن الحكم وأعوانه، وفي الثالثة كان يتواجد عبد الله بن الزبير.
سُئل الأصبغ بن نباته، لماذا تركتم هؤلاء أحياءً؟! فأجاب قائلاً: كانت أكفّنا على أغماد سيوفنا ننتظر أمر أمير المؤمنين (ع) فيهم.. لكنه (ع) أمر بالعفو عنهم جميعاً (المستدرك: الباب22، جهاد العدو).
ثم بعث الإمام (ع) عائشة إلى المدينة، يحرسنها جمعُ من النسوة.
ما حكم اغتيال المعارضين السياسيين في الدين الإسلامي الحنيف؟ وما هي وجهة نظركم حول أحداث التفجيرات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية؟.
إن الإسلام دين العقل والمنطق، وهو يعارض جميع أشكال العنف والاغتيالات، ذلك لأنها -فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان- تستتبع اختلال النظام وسلب الأمن العام من المجتمع.
جاء في رواية صحيحة أن أبا الصباح الكناني قال للإمام جعفر بن محمد الصادق(ع): لي جارٌ يسبُ الإمام أمير المؤمنين (ع)، فهل تأذن لي أن أقوم بما يسكته؟! قال له الإمام (ع): (أو تستطيع؟) فقال أبو الصباح: أقسم بالله لو أذنت لي لدّبرت له كميناً، حتى إذا وقع فيه، علوته بسيفي.
قال الإمام (ع): (يا أبا الصباح، هذا الفتك، وقد نهى رسول الله (ص) عن الفتك، يا أبا الصباح، إن الإسلام قيد الفتك) (الكافي: ج7، ص375) معنى الفتك هنا الاغتيال، ومعنى (الإسلام قيد الفتك) أي مانعٌ منه.
ويحدثنا التاريخ أنه لما كان مسلم بن عقيل (ع) في صدد تمهيد أوضاع مدينة الكوفة لقدوم الإمام أبي عبد الله الحسين (ع) إليها، وصلها ابن زياد بأمر من يزيد بن معاوية، وأعادها للسيطرة بقوة وإرهاب الحكم العسكري. في أحد الأيام قرر ابن زياد زيارة (شريك بن الأعور) وكان من وجهاء الشيعة في الكوفة، فراح شريك يتفق مع مسلم بن عقيل الذي كان في داره، أن يختبئ في إحدى زوايا الدار، فإذا نادى (شريك) بشربة ماء، يخرج مسلم ويغتال ابن زياد، وتنقلب بذلك أوضاع الكوفة وتعود لصالح مسلم، ولكن عندما حضر ابن زياد في دار شريك، لم يفعل مسلم بن عقيل شيئاً،وفي مقابل اعتراضات شريك،استشهد مسلم بحديث لرسول الله (ص)، قال فيه: (إن الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمنٌ) أي إن الإيمان يمنع من الاغتيال، والمؤمن لا يقتل أحداً غيلةً.
نعم، عند الجهاد، المسلم يَقتل ويُقتل، ولكن الجهاد غير القتل غيلةً (الاغتيال).
وفي الجهاد، أيضاً لا يبدأ المسلمون بالقتال، بيد أنهم بعد حصول مهاجمة الأعداء لهم، يصبحون مرغمين على الدفاع عن أنفسهم.
وأما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ذهب على أثرها الكثير من الضحايا الأبرياء، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة، فأنا ضمن إعرابي عن تعاطفي ومواساتي لأسر الضحايا، أقول: هذه الأعمال لا تنسجم بأي وجه مع الدين الإسلامي المبين، الذي هو دين العقل والسلام والرحمة، وإن اتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب، والدفاع عن الإرهابيين، من كبائر الذنوب التي لا تغتفر.
ورغم حصول أعمال عنيفة وغير لائقة ارتكبها بعض الحكام المستبدين والأشخاص الانفعاليين، على مدى التاريخ،تحت غطاء الاسلام، وباسمه، إلا أن المعيار لدينا هو إسلام رسول الله (ص) والأئمة المعصومين (ع)، الذين كانوا مثالاً للرحمة والرفق واحترام حقوق الناس.
ويتعين على عقلاء العالم إجراء التفاهم والتشاور فيما بينهم، لأجل التوصل إلى الطريق الصحيح لمواجهة الإرهاب، والكشف عن علله وأسبابه، والإقدام على اجتثاث جذوره، لأن الحرب الحقيقية والمؤثرة على الإرهاب هي الحرب على أسبابه ودوافعه.
من المؤسف جداً أن نرى (إسرائيل) في هذا الخضم تسيء استغلال الجو المفتعل على الإسلام والمسلمين، وتشن هجمات بربرية على الشعب الفلسطيني المظلوم، وتضيق عليه الخناق من جميع الجهات، غافلةً عن أنه لا دوام لحكومة أو كيان مع الظلم.
هل حد (المحاربة والإفساد) الشرعي يشمل أيضاً ميدان الثقافة؟ يعني إذا قرر حاكم الشرع أن أقوال أو كتابات شخص معين تسبب الاختلال في المباحث العلمية والثقافية والدينية والأخلاقية، فهل يعتبر الكاتب أو القائل محارباً ومفسداً في الأرض؟ ولماذا؟.
أصل الفكر وما يخطر على بال المرء، وذلك الذي ينتج عن اختلاف أو توافق فكرين، ليس في اختيار الإنسان مطلقاً، وإن كان من الممكن أن تكون بعض مقدمات ذلك اختيارية.
إن الأفكار تبرز وتظهر في الذهن بعد أن تعبر مراحل معقدة، بعيداً عن أي عامل خارجي بعينه، أو حتى دون قصد وإرادة صاحب الفكرة في حالات كثيرة، وإن مجرد الأفكار والخواطر التي ترد على ذهن الانسان، لا تبعث أبداً على المؤاخذة والعقاب، من الناحية العقلية، ومن الوجهة الأصولية التي يقبل بها العقلاء، ومن وجهة نظر جميع الأديان السماوية. وفي أية محكمة أصولية مقبولة، لا يُحاكم أحدٌ بسبب امتلاكه وجهة نظر خاصة، أو فكرة معينة حول أي موضوع كان.
إن محاكم تفتيش العقائد التي ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى، من التجارب المرة والنقاط المظلمة في حياة البشرية، والتي تذكر اليوم بخجل وحياء.
إن بلوغ الفرد مرحلة التكليف تجاه أصول الدين، التي هي من الأمور الاعتقادية، لا يعني خلق تصور فكرة خاصة في فضاء ذهن هذا الفرد، بل يعني السعي لإيجاد مقدمات الاعتقاد الذهني، ولزوم الإيمان بها، ورغم أن الإيمان يكون بالروح والقلب، إلا أن قبول آثاره وتبعاته العملية والأخلاقية، هو مورد اهتمام وتوجه الأديان.
في الحقيقة أن معنى الإيمان هو الالتزام والتقيد بأصول صارت فكراً وعقيدةً تسري في روح الإنسان وذهنه بعد مرحلةٍ من التفكير والتدبر.
كما أن رسالة الأنبياء (ع) هي دعوة للحق، وإيقاظ النفوس، وهداية الناس لطريق التفكير والتدبر والاستدلال والتعقل وصولاً إلى الإدراك الصحيح لعالم الخلق والمبدأ والمعاد.. ولم يُأمر أي نبي بإجبار الناس على الإيمان بأصول الدين، والآية الشريفة (لا إكراه في الدين) تشير إلى هذه الحقيقة.
أما فيما يتعلق بموضوع الإعراب عن الفكر والعقيدة وإظهارها، فنقول إن إظهار أي عقيدة وفكر، هو من الحقوق الأولية لأي إنسان، وإن عقلاء العالم لا يقفون مانعاً، في أي وقت، أمام ما يفكر به الإنسان، وحقه في الإعراب عنه، وسلب هذا الحق منه ظلم له، فكما أن من حق الآخرين الاطلاع على أي فكر أو عقيدة، فإن محض إظهار الفكر واطلاع الناس عليه لا ربط له البتة بأي عنوان من العناوين الجزائية (التي توجب العقاب)، من نحو: الإهانة، الافتراء، واستغفال الناس، وما شابه ذلك.
وكل ما ذكر في شأن الضلال، في بعض المصادر الإسلامية، لا يعني أبداً تحجيم وقمع الآراء والعقائد المخالفة التي يظهرها أصحابها من طريق المنطق والاستدلال، بل عند إمعان النظر في الآيات والروايات وسيرة المعصومين (ع)، يُفهم أن المقصود بذلك ما يقوم به المخالف المعاند من اللجوء إلى أساليب الكذب والخداع والإهانة والافتراء، وترك الاستدلال المنطقي والبراهين العقلية، وهو بهذه الطريقة غير العلمية بصدد تشويش أذهان الناس، وإفساد عقائدهم، وهدم قيم المجتمع، وتخريب بنيته العلمية والثقافية، هنا يتأتى طرح العناوين الجزائية.. في الحقيقة أن منع أو فرض القيود – وهو نوع من أنواع التعزير- هو بسبب تلك العناوين الجزائية، وليس لمجرد إظهار الفكر والعقيدة والإعراب عنهما.
من المؤكد أن إحراز تلك العناوين الجزائية (موجبات الجزاء) أمر في غاية الصعوبة، ويحصل أن بعض الأنظمة الحاكمة، ولأجل تحقيق أغراض ومآرب سياسية معينة أو لتصفية حسابات حزبية، أن تقوم بالتضييق أو الوقوف أمام المنتقدين وأصحاب الرأي والفكر المخالف، عن طريق اتهامهم بتهم ذات عناوين جزائية، من نحو: إهانة المقدسات، إفساد المجتمع، الإخلال بالأمن الاجتماعي.. الخ، وعلى نحو الإجمال نقول إنه كثيراً ما يلجأ الحاكم (من يتولى القضاء) أو بعض الأفراد، بسبب العناد أو لأغراض أخرى، إلى الخلط بين الأمور الثقافية والجزائية، فلكي نحول دون سوء استغلال عناوين من مثل: حرية التعبير عن الرأي، أو الإضلال، أو الإهانة، أو الإفساد، ونحو ذلك- من قبل الطرفين (الحاكم والمحكوم)، يلزم تشكيل هيئة محايدة منتخبة من قبل الشعب، تضم أفراداً وأصحاب رأي وخبرة في هذه الأمور، يكون رأيها ملاك أي حكم قضائي يصدر عن المحاكم المعنية بالنظر في هذه الشؤون وما يرتبط بها، حتى نضمن بذلك عدم هدر حقوق الأفراد، واحترام الحق العام في آن معاً.
وبالجملة، لابد أن نلتفت إلى أن الفكر أو العقيدة الباطلة، ينبغي أن نردّ عليها بفكر صائب وعقيدة صحيحة، من دون اللجوء إلى العقاب والتضييق على صاحب ذلك الفكر وتلك العقيدة، فقد أثبتت التجربة العملية أن مواجهة الطرح الثقافي والفكري بأسلوب العقاب والمجازاة، يؤدي إلى نتائج عكسية.
كما أن أنبياء الله (ع) والأئمة المعصومين (ع) كانوا يواجهون الأفكار والميول الإلحادية بأفضل طرق وقواعد البيان والاستدلال.
فعلى سبيل المثال، كان الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) يعقد جلسات حوارية مع الملاحدة ومنكري وجود الله سبحانه والنبوة، ويستمع إليهم بدقة وصبر، ثم يبطل شبهاتهم ويدحض دعاواهم بطرق المنطق والاستدلال العقلي.
يروى في هذا الصدد أن المفضل -وكان من خلّص أصحاب الإمام الصادق (ع)- كان ذات يوم يصلي في مسجد النبي (ص)، وفي هذه الأثناء دخل إثنان من الملاحدة إلى المسجد، فجعلوا يتحدثون بصوت يسمعه المفضل. من جملة ما تناولوه في حديثهم، موضوع النبوة، ونبي الإسلام (ص)، مدعين أن النبي الأكرم (ص) كان رجلاً نابغةً، استهدف في دعوته إيجاد تحولٍ في مجتمعه، ورغم أنه لم يكن مقتنعاً بدينه، إلا أنه رأى أن الدين هو أفضل طريق لتحقيق مثل هذا التحول (!!) لما سمع المفضل هذا الكلام غضب أشدّ الغضب، وراح يعنّف ذينك الملحدين بالكلام، فقالا له: أنت أي شخص تتبع؟ إذا كنت تتبع جعفر الصادق، فعليك أن تعلم أننا نتحدث عنده بمثل هذا الكلام، بل نتقصى في الاستدلال ضد وجود الله، ثم تراه ليس فقط لا يغضب، بل يبالغ في الاستماع إلينا، حتى نظن أنه قبل كلامنا، لكنه لم يلبث أن يردّ حججنا ويبطل كلماتنا بمنتهى الدقة والإحكام.
إن سمو الإسلام وعلو منزلته، على جميع الأصعدة، يرتبط بهذه النقطة، أي إفساح المجال للمحالف والمخالف ليعبر عن رأيه واعتقاده بكامل حريته، وتوفيره لأرضية البحث العلمي في جميع المجالات، ولجميع الأشخاص، بلا استثناء، ويجيب على جميع التساؤلات من طريق المنطق والاستدلال فقط، وقد دلّت التجربة أنه كلما توفرت مثل هذه الأرضية، كان الإسلام، في النهاية، هو المستفيد، وبالعكس، فإنه كلما لجأت الحكومات أو الأفراد إلى أساليب القمع والقهر، كانت النتيجة سلبية تماماً.
هل إن حد (الحرابة والإفساد في الأرض) يشمل المجال السياسي، يعني إذا كانت هناك أنشطة سياسية سلمية معارضة للحكومة، ورأى الحاكم الشرعي أنها مضرة ومخلة بالأمن الوطني، فهل يعتبر الأشخاص أو الجهات التي تقوم بهذه الأنشطة محاربين ومفسدين في الأرض؟.
إن الأنشطة السياسية، من قبيل: الانتقاد، التظاهرات السلمية، كتابة المقالات، تأسيس الأحزاب والجمعيات، وما شابه ذلك، ليست مصداقاً لأي عنوان من عناوين (المحاربة) و (البغي) و(الإفساد)، لأن قوام (المحاربة)، إرعاب الناس، تهديد أمن المجتمع، بواسطة استخدام القوة والسلاح، وكذلك (البغي) فهو العدوان المسلح على الآخرين، والخروج من حدود الحق والعدالة، أما (الإفساد) فإذا كان متقارناً مع (المحاربة)، يصبح موضوعاً ينطبق عليه حكم الآية الشريفة، وإذا لم يكن كذلك، بل كان مستقلاً، فإنه يصدق عليه الحكم في الحالات التي توجب ضياع حقوق وأمن مجموعة من الناس، هذا على حين أن الأنشطة السياسية ليست على هذا النحو، بل تأتي في بعدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحقاق حقوق المجتمع.
إضافة إلى ما تقدم، فإن العناوين المذكورة، هي من العناوين القصدية، أي التي يتوقف إحرازها وصدقها على إحراز قصد الشخص، أو على الأقل علمه بآثار عمله، وإحراز هذين الأمرين، من الناحية الشرعية، له شروط خاصة، ولا يكتسب بسهولة صورة الفعل الذي يستدعي الأحكام الآنفة الذكر.
و (أصولاً) بالنسبة للموارد التي توجد فيها أقل شبهة، من ناحيتي موضوع الجرم أو الحكم، فإن الشارع المقدس يأمر بالاحتياط، لا سيما فيما يرتبط بالنفوس، والدماء، والأموال، وماء وجه الأفراد -أي اعتبارهم وكرامتهم-.
وبكلمة أخرى، ففيما يتعلق بالأنشطة السياسية، ينبغي ملاحظة ما يلي:
أولاً- إذا لم يكن النشاط السياسي مصداقاً لأي عنوان من العناوين السالفة، فلا يوجد أي مبرر شرعي لمنعه، أو اعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يقومون به، في القوانين الإسلامية، وسيرة الرسول الأكرم (ص) والإمام علي بن أبي طالب (ع) لا أثر ولا وجود لاعتقال الأشخاص لمجرد اختلاف العقيدة، أو إبداء موقف منتقد ومعارض للحكم. إن المعارضين السياسيين للإمام علي بن أبي طالب (ع) كانوا يجاهرون بمعارضتهم للإمام(ع) أيام حكومته، حتى أن عبد الله بن الكواء -وهو من الخوارج- كان يطلق الشعارات المعادية علناً في وجه الإمام (ع)، إلا أنه طيلة الوقت الذي لم يبادروا فيه إلى العمل المسلح، ليس فقط لم يعتقلهم الإمام أمير المؤمنين (ع)، بل إنه (ع) كان يجري عليهم رزقهم من بيت المال أيضاً.
ثانياً: لو فرضنا أنه يجوز شرعاً اعتقال الناشطين السياسيين ومحاكمتهم، فإنه ليس صحيحاً أن ينظر القضاة والمحاكم المنتسبة للدولة، وهي ذات مصالح تجعلها غير حيادية -ومن شروط القاضي عدم التحيز لأحد طرفي الدعوى-.
ليس صحيحاً أن تنظر أمثال هذه المحاكم، في دعاوى وقضايا من هذا النوع، أي القيام بأنشطة سياسية معارضة للحكم، ولهذا ينبغي النظر في هذا القبيل من الاتهامات، في محكمة يرضى بها الطرفان، بحضور هيئة محلفين محايدة تماماً، ومنتخبة من قبل الشعب، وتضم أهل الخبرة والدراية في الشؤون السياسية.
من وجهة نظر سماحتكم، هل يعتبر إجراء الحدود الشرعية، في حد ذاته، عملاً من أعمال العنف؟.
بالرغم من تعيين حد شرعي خاص لبعض الذنوب والجرائم الكبيرة، إلا أن هناك أحكاماً فرعية شرعت في هذا الصدد، ومن جملة هذه الأحكام الفرعية ما يلي:
أ) إذا كان مرتكب العمل الخاطئ، لا يعلم أنه سيأثم عليه، أو لا يدري أنه جريمة، فإنه لا يُجرى عليه الحد الشرعي.
ب) إذا كانت هناك شبهة في العمل، فكذلك لا يُجرى عليه الحدّ.
روي عن رسول الله (ص) قوله: (ادرئوا الحدود بالشبهات) (الوسائل: ج4، ص24، مقدمات الحدود).
ج) إذا تاب المذنب قبل اعتقاله، سقط عنه الحدّ.
د) لا يجرى الحدّ على أحد في أرض العدو، روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قوله: (لا يُقام على أي أحدٍ حدّ بأرض العدو) (الوسائل: ج1، ص10 مقدمات الحدود).
هـ) إذا ثبت الحدّ، من طريق إقرار المتهم، فلإمام المسلمين أن يعفو عنه. وطريق إثبات الذنوب الجنسية، هو نوع من الإقرار، وليس شهادة شهود.
روي عن الإمام أمير المؤمنين (ع): (من أقر عند تجريدٍ أو تخويفٍ أو حبس أو تهديد، فلا حدّ عليه) (الوسائل: الباب السابع من أبواب السرقة).
و) الجميع متساوون أمام القوانين والحدود الإلهية. جاء في رسالة الإمام أمير المؤمنين(ع) إلى أحد ولاته على الأقاليم، وكان قد أخذ أموالاً من بيت المال بغير حق، (والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني بإرادة، حتى آخذ الحق منهما وأزيل الباطل عن مظلمتهما) (نهج البلاغة، الخطاب 41).
إضافة إلى ما تقدم، هناك -في الإسلام- طريقان أساسيان لإثبات الجرم أو الذنب، وبالطبع فإن بموجبهما يتضيق مجال إجراء الحدود الشرعية إلى أدنى حد، هذا الطريقان هما:
أ) شهادة أفراد عدول، يمكن الاعتماد على شهاداتهم.
ب) إقرار المتهم.
وبالطبع، فإن الغالب هو الاكتفاء بشاهدين عادلين، أو الاكتفاء بإقرارين، ولكن فيما يتعلق بالأمور الجنسية المحرمة، من قبيل الزنا واللواط، يلزم توفر أربعة شهود، أو أربعة إقرارات.
في باب القصاص، هناك (القسّامة)، يعني أن يُصار إلى خمسين قسماً، وهو ليس موضوع بحثنا الآن.
هذا، وقد قرر بعض أكابر العلماء أنه يكفي أيضاً علم القاضي، ولكن كفاية علمه في الأمور الجنسية المحرمة محل إشكال، وبما أن توفر أربعة شهود رأوا عملاً جنسياً محرماً بأم أعينهم أمرٌ نادر الحصول، فإن طريق إثبات الجرم يكاد يكون منحصراً في إقرار المتهم
وبعد إتمام كل هذه المراحل، تأتي مرحلة إجراء الحدّ الشرعي.
هذا الأمر يختص به الحاكم الشرعي الذي تتوفر فيه كافة الشرائط، وفي زماننا هذا يكون في عهدة السلطة القضائية، ولا حقّ لأي كان أن يقوم بإجراء الحدود الشرعية، أو يعزّر أحداً، أو يتعرض بسوء للمتهمين.
ومن المؤكد أن إرشاد وهداية غير العارفين بالحدود والأحكام الالهية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه الخاصة، هو واجب جميع الناس.
وهذا الأمر أوجبه الله تعالى على عباده، لأجل إصلاح وتطهير محيط الأسرة والمجتمع من الخبائث والمفاسد.
هل الأحكام الواردة في الفقه الإسلامي حول الجهاد الابتدائي، والارتداد، تهيء الأرضية لنوع من العنف الديني؟.
التشريع الكامل والصحيح، هو التشريع الذي ينسجم مع نظام الطبيعة والتكوين، بل إن التشريع هو مظهر من مظاهر التكوين. ومن طبيعة نظام التكوين أن يتوائم الرفق مع الشدّة، وكل ظاهرة عبارة عن مركب من هذين القسمين (الرفق والشدة)، قسم الرفق هو أساس أو أرضية فاعلية وجدوائية أو فائدة أية ظاهرة في نظام التكوين، وقسم الشدّة هو حافظ كيان وثبات تلك الظاهرة، وهو محور دوامها؛ فعلى سبيل المثال ترى الأرض مركبة من سهول متتابعة وناعمة، وجبال شديدة ومرتفعة، الأرض السهلية هي محل السكن والزراعة وجميع الأعمال النافعة لبني الإنسان، ولكن ثبات واستقرار الكرة الأرضية يرتبطان بالجبال الضخمة والشاهقة.
نقرأ في سورة المرسلات، من القرآن الحكيم، (وجعلنا فيها رواسي شامخات)، وفي سورة النبأ: (ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً).
وفي الطبيعة نرى أيضاً أن الأغصان الّلينة والناعمة للشجر، هي المكان الذي تقطف منه الثمار، أو الذي يعطي فوائد أخرى معلومة، ولا يمكن بحال أن تعطي سوق الأشجار وجذورها الثمار، لكن بقاء الشجر وحياته يكون بجذوره وسوقه القوية.
إن محور إدراكات وحركات الإنسان، أعصابه وعضلاته اللينة، ولكن ثبات بدنه يتوقف على عظامه، وإذا لم يؤمّن ثبات البدن واستقراره، اختل سائر نظام الإدراكات والحركات.
وعلى هذا الأساس، إذا قبلنا أن تشريع الأحكام والأوامر والنواهي من لدن البارئ عزّ وجلّ- وهو خالقنا والعالم بما ينفعنا ويضرنا- أمر ضروري ولازم، في عالم التشريع أيضاً، وإن كان أغلب الأحكام والقوانين شرع بنحو الرفق واللطف بهدف بناء الإنسان معنوياً، وتربيته، وحسب ما ورد أن: (الإسلام هو الشريعة السمحاء السهلة) وكثيراً ما جاء الحثّ فيها على التسامح والعفو وغض الطرف وما إلى ذلك، ولكن في عين الوقت لو لم يكن هناك حزم في مواجهة الإعلام المسموم والمنحرف، فإن أساس الأخلاق والقيم، والشريعة والقوانين، سينهار، وسيتفكك نظام المجتمع الإسلامي، فكما أن هناك مراتب ودرجات لعلاج أمراض الجسم، وكثيراً ما تستدعي الحالات المرضية المستعصية الكيّ وقطع أحد الأعضاء، على نحو ما قيل من أن (آخر الدواء الكيّ)، فكذلك تتطلب بعض العلاجات النفسية التي يراد بها إصلاح الإنسان والمجتمع وتربيتهما، الحزم والشدة.
نعم، إن أي مصلح اجتماعي حريص يحتاج إلى العمل بالرفق واللطف، ومعاملة أمته معاملة أبوية، غير أنه إذا اصطدام أحياناً بأناس عنيفين وسيئي الطويّة، يستغلون أجواء الحرية واللاعنف استغلالاً سيئاً، فلا حل أمامه سوى اللجوء إلى الشدة والحزم، ذلك لأن استتباب الأمن والهدوء العام في أي محيط اجتماعي يتقدم في الأهمية على أي شيءٍ آخر.
في علم الأصول، يوجد باب تحت عنوان (باب التزاحم)، يعني إذا ما حصل في بعض الموارد تعارض وتصادم بين المصالح والمفاسد، بحيث يتعذر الجمع والتوفيق بينها، فإن العقل والوجدان يحكمان بالمقارنة بينها، وتقديم ما هو أهم، فعلى سبيل المثال: إذا كان الدواء ضرورياً لمعالجة حالة من حالات مرضى السرطان، وهذا الدواء تصاحبه أضرار جانبية معينة، فلأن ضرر السرطان يفوق جميع تلك الأضرار الجانبية، يصبح من اللازم استخدام الدواء وتحمل كل الأضرار الجانبية المترتبة عليه، في المجال الاجتماعي كذلك، فإذا وقع تزاحم وتعارض في مورد معين بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة للمجتمع، وامتنع الجمع والتوفيق بينها، في هذه الصورة يصير لزاماً تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد.
مع أخذ هذه الإيضاحات بنظر الاعتبار، يتبين تماماً أنه لا يوجد شيء في الإسلام باسم الجهاد الابتدائي المحض، وسائر الجهاد يعود في حقيقته إلى الجهاد الدفاعي، وإن عقل ووجدان أي إنسان سالم الطويّة، يحكمان بضرورة ولزوم الجهاد الدفاعي.
فمرة يكون الدفاع عن شخص، ومرةً يكون عن عرضٍ أو مالٍ، وحيناً يكون الدفاع عن العدالة، وتارةً يكون الدفاع عن شعب، فإذا فرضنا أنه في دولةٍ ما يوجد شعب يميل بفطرته إلى النقاء والطهر، ويطلب الحقّ والعدالة الاجتماعية، ولكن ملكت عليه الأرجاء مجموعة قليلة من السلاطين والمتجبرين، واستفردت هذه القلة بسياسة واقتصاد وثقافة ذلك البلد، وصارت سداً أمام رقي هذا الشعب في ميادين العلم والثقافة والمعارف والحقوق، ثم استنجد أناسه المظلومين والمحرومين، سواء بلسان الحال أو المقال، بالآخرين، أفلا يحكم العقل والوجدان، بضرورة المبادرة إلى التصدي لتلك الحكومة الظالمة أو أولئك الحكام الظلمة، عند القدرة والاستطاعة، لأجل إنقاذ شعبٍ يعاني الأمرين تحت سلطة أقلية غاشمة، وبالتالي ليستطيع هذا الشعب أن يتمتع بحقه في اكتساب المعارف والعلوم والثقافة الغنية وبسط العدالة الاجتماعية بين أفراده؟!.
يقول الله تعالى في قرآنه الحكيم، في سورة النساء: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها).
يستفاد من هذه الآية الشريفة، أن المستضعفين والمحرومين الذين نفد صبرهم في تحمل ظلم الظالمين، يطلبون بلسان الحال والمقال، العون من الرجال ذوي الغيرة والشهامة ومن جميع الأحرار..إنقاذ هؤلاء هو أحد أهداف الجهاد الإسلامي.
وفي سورة البقرة، في قصة طالوت ومقتل جالوت على يد نبي الله داود (ع)، يقول تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.. ولكن الله ذو فضل على العالمين)، ويقول سبحانه وتعالى أيضاً: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله).
وفي سورة الحديد، ورد قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديد ومنافع للناس).
وفق مفاد هذه الآية المباركة، فإن الهدف من إرسال الرسل هو تطبيق العدالة الاجتماعية، وعونهم في ذلك الحديد الصلب، أي الأسلحة، وبالتالي فإن الهدف من الجهاد الإسلامي، هو تطبيق العدالة الاجتماعية، وإزالة الفتن، والدفاع عن المعارف الحقة، وإحقاق حقوق البشر الاجتماعية، وليس فتح البلدان.
وأما بخصوص (الارتداد) فينبغي الالتفات إلى أن الفحص والتفتيش عن عقائد وأعمال الناس حرامٌ شرعاً، والأصل في الناس هو البراءة، وليس لنا الحق بحالٍ أن نتهم الناس، بلا حجة أو دليل واضح، كما لا يجوز أن نتفحص ونراقب عقائد الناس وأعمالهم عن طريق نصب أجهزة التصوير والتنصت، يقول الله تعالى: (ولا تجسسوا)، فكما أن الله سبحانه هو ستّار العيوب، فإنه يتعين على العباد أن يتستروا على عيوب بعضهم البعض، ولا يفشوها.
بيد أن الحرية لا ينبغي أن تجرئ أحداً على تجاوز حقوق الآخرين، وعلى هذا الأساس فإن الجهر بالارتداد، والفسوق، وهتك الحياء العام، والنيل من مقدسات الناس، وهدر حقوقهم، وتلويث المحيط الاجتماعي، لا يجوز بحكم الشرع والعقل.
إن الإسلام لم يجبر الكفّار قط على قبول عقائده، ونحن نعلم أن الدين والعقائد لا تتحقق من طريق الإكراه والجبر (لا إكراه في الدين)، ولكن الشخص المسلم الذي لديه سابق عهدٍ في الاسلام، إذا كان معلناً بارتداده، وراح يشكك الناس، ويجعل المقدسات الدينية تحت علامات الاستفهام، يصبح مثله مثل الغدة السرطانية، لا تلبث أن تسري وتنتشر في جسم المجتمع تدريجياً، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير بعض المؤامرات السياسية التي تستهدف النيل من الإسلام والمسلمين، مما ينطبق عليه حد المحاربة في حقيقته.
وفي الضمن، يلزم الانتباه إلى أن مجرد اختلاف الأنظار في فهم مباني الإسلام، واستنباط أحكام الدين، أمر طبيعي، ولا يحق لأحد أن يجعل من فهمه واستنباطه معياراً للحق، فيرمي مخالفيه بالانحراف والارتداد.
وحتى إذا افترضنا أنه في ظروف معينة يترتب على تنفيذ حكم ما مفسدة أكبر، فإنه بمقتضى قاعدة (التزاحم) يتوجب صرف النظر عن إجراء ذلك الحكم.
لقد جاء في حديث عن النبي الأكرم (ص): (لولا أني أكره أن يقال إن محمداً استعان بقومٍ حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قومٍ كثير) (الوسائل: ج3، ص5، حدّ المرتد).
فلا بد أن هذا الحديث ناظرٌ إلى أناس كانوا يناصرون رسول الله (ص)، لأجل مآرب سياسية آنية، ولكنهم كانوا كفاراً ومفسدين، وبالتالي مستحقين للقتل، غير أن الرسول (ص) لم ير في قتلهم، في تلكم الظروف، صلاحاً.
يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف، أنه يجب مراعاة ظروف الزمان والمكان في تنفيذ الحدود الإلهية، لأن الأصل في إجراء الحدود الشرعية هو حفظ سلامة المحيط الاجتماعي، وليس الانتقام من المنحرفين.
وبجملة، إن إجراء الحدود الشرعية، يجب أن يتم في محيط إسلامي، بهدف تنبيه المسلمين، وليس في محيط كافر، فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) قوله: (لا يقام على أحدٍ حد بأرض العدو) (الوسائل: ج1/ ص10 – مقدمات الحدود).